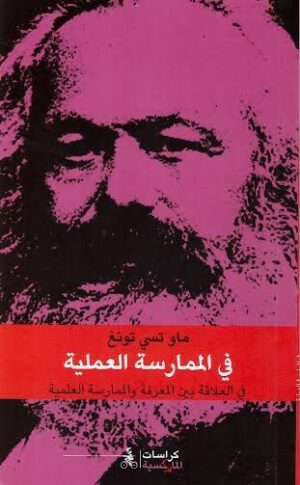ليست الأحداث – في الحكايات كما في الحياة – سوى علامات على خط الزمن، نعرفه بها وبها نتعرف إليه، أمّا زمن فلسطين النكبوي فمرصّع بعلامات / ندوب تَسهُل قراءتها على أجساد “الشخوص” استباحة وسجناً وعزلاً وطرداً لمصلحة زمن كولونيالي ذي مخالب وبلا قلب، وبهذا تبقى النكبة الحدث المؤسس في حكاية الفلسطينيين، وتبقى البلاد المتذكَّرة، أو القادمة من ذاكرة الآباء، مكاناً أُمّاً، بينما يلعب المخيم، كمكان، دور المناوب المثابر عن فلسطين المنتظرة.
لم يترك الفلسطيني المنكوب حيلة إلّا واتبعها كي يرمم خراب زمنه، فغيّر بالبندقية معنى مفردة خيمة، كمُفتتح لشرعنة قاموس جديد، أحرج بجدارة رواية التعالي والنفي والإلغاء، وهنا كان الأدب في صُلب المهمة، مؤسساً للفعل أو منجدلاً معه، أو مستفيداً ممّا يفتحه من فضاءات.
الآن، أُغلقت الفضاءات، وضاقت الأرض، وبلغ مأزق الوجود الفلسطيني قاعاً غير مسبوق. فمنذ خسارة الجغرافيا الأم، تتابعت الخيبات، وتغير العالم كثيراً لمصلحة الأقوياء، وانكفأت السياسة الوطنية إلى مربع وظائفي فقير محكوم بالانتظار، وتحول قسم كبير من حالة اللجوء إلى شتات بعيد، وهذا كله جعل محاولة استئصال الرواية الفلسطينية مغرية من جديد.
لقد حققت الكولونيالية الصهيونية جملة مكاسب على صعيد التوسع في احتلال المعنى، حوّلتها من متهَمة بالعنصرية إلى متهِمة، وأكملت “تأميم” إرث اليهود واليهودية والاستحواذ عليه، فوظفت التوراة كدليل إرشاد للاحتلال، كما جنّدت مآسي الضحايا من اليهود كذريعة جلادين، وتحت هذا السقف تم تفصيل مفردات خاصة دمغت الفعل الصادر عن الفلسطيني بالإرهاب المرتبط بنوازع دينية انفعالية غير مفهومة عقلانياً، بينما أصبح العنف الديني المتكىء على تأويلات توراتية أو مسيحانية “جريمة كراهية”.
لقد وصل المنشار إلى العظم الآن، وصارت الحرب تدور على شرعية قاموس فلسطين مفردة تلو أُخرى.
مع هذه الملابسات كلها، من المهم الإصغاء إلى ما يقترحه الأدب بصورة عامة. وهنا، لدينا في هذه العجالة فرصة كي نصغي إلى مادة قصصية قادمة من المخيم، توأم النكبة، ومن لبنان تحديداً حيث الوجود الفلسطيني المركَّز، والمعلق خارج الجغرافيا وخارج التاريخ؛ مادة مكوّنة من 14 مساهمة أنجزها كتّاب غير محترفين، تحت عنوان “حب في المخيم”، صدرت حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وهي حصيلة ورشة للكتابة الإبداعية نظمتها المؤسسة في بيروت في خريف سنة 2018، بإشراف الأديب اللبناني الياس خوري، وبدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان وصندوق الأمير كلاوس ضمن مشروع: “صِلات: روابط من خلال الفنون”.
تتفاوت المساهمات في مستواها، وتختلف في زوايا مقاربتها لموضوعها، لكن توحّدها الجماليات البسيطة، والتقنيات الزاهدة، وغلبة التسجيلية، فهي تتكىء على ذرائع سردية تتوزع بين رسالة حب موجهة إلى طفلة لن تولد، وسيناريوهات تلاحق شخصاً غامضاً، ولعبة تتخذ فيها المرايا شكل ثيمة تضبط البحث عن صورة الذات وصورة المخيم، إلى جانب ما يشبه الشهادات الذاتية النابضة بالحس المرهف.
لكن أكثر ما يبهج في مجموعة “حب في المخيم” لغتها القادمة من الحياة، بحيث يعيد هذا التعامل مع اللغة شحنها من جديد، ويعيد تعريف الأمل عبر فهم نبيه للقسوة وهي ترتسم على أجساد المنفيين المحصورين بين جدران “صديقة”.
ليس الحب وحده ما يصلح لأن يكون عنواناً لهذه المجموعة التي تتخذ من الحب أداة كفوءة لتظهير الكراهية وإدانتها، بل السخرية الخفيفة الظل التي لا تبهّت سياق التراجيديا وإنما تعمّقه، والطزاجة القادرة على الإدهاش، وشجاعة التحديق في المرايا، والنجاة من رذيلة الأبوية والوصاية، واتخاذ الألم الفردي العاري مصباحاً يسلط الضوء على الحالة الجماعية ويشهد عليها.
تستلهم المساهمات الواقع، لكنها تحدّق فيه بعين غير مؤدلجة، عين وفيّة للمشهد ذاته، تُسفر عن توصيف من لحم ودم، فالمخيم ليس خرافة، إنه حقيقة يومية لها ملمس ورائحة، حقيقة مكانية وزمانية محشورة الشخوص، معطلة الأحداث، فجائعية الحبكات، وبهذا تتجاور النقائض: القوة مع الهشاشة الإنسانية؛ الأمل مع اليأس التام؛ الالتزام مع التبجح بالانسلاخ؛ القبض على شعلة البقاء مع الشعور الصارخ باللاجدوى.
تتلمس الكتابات الحدود بلا استثناء وتعرّي قسوتها: الحدود التي تفصل بين شاب وشابة لتحيل حبّهما المحكوم بشروط الوضع العام إلى حلم عابر؛ الحدود التي تفصل بين طالبة متفوقة جداً وبين حلمها بدراسة الطب لأن الوظائف ممنوعة على الفلسطيني؛ الحدود الفاصلة بين شاب ووظيفة مستحقة، الأمر الذي يدفعه في طلب التوظيف إلى التخلي الموجع عن أصله، وإلى تبديل لهجته في أثناء مقابلة العمل، في تمرين يسمح له بملامسة الحظ مجرد ملامسة، ويتيح له وضع العنصرية أمام مرآة فاضحة. وأخيراً الحدّ الفاصل بين مريض وسرير في المستشفى، وبين مريض وعملية جراحية يموت من دونها، لينتهي المشهد بعابرة “وتنساش تحاسب بدل إسعافك بس تطلع” (ص 141).
توقظ العقبات الجائرة في وعي ضحاياها أسئلة الخلاص، وتؤجج النقاش الفلسطيني القديم ما بين جدوى الحلول الفردية وثمن الخيار الجماعي، في مكان آخذ في التقلص والتفكك، وفي مواجهة عنف صامت وعميق ومثابر.
هنا يتحول المهرب أبو الخيزران من شخصية ورقية في رواية “رجال في الشمس” لغسان كنفاني إلى كائن واقعي يمشي في شوارع المخيم ومعه اقتراحه الفردي البرّاق؛ تتبدل ثيابه ولهجته وجنسيته، تتغير وسيلة “التهريب” من شاحنة إلى قارب، لكن المنقول ثابت، هو الفلسطيني، بينما يصبح المصير المؤلم في صحراء الكويت مفتوحاً على احتمالات الغرق والنسيان.
وأمام الطاقة السلبية وحديث الخيبات ومنطق الانسحاب تعلو أصوات واثقة: “المخيم هو وجهتنا إلى البلاد” (ص 49)، وأيضاً: “ومنهم مَن أبى الخروج [من مخيم اليرموك] كي لا يضيع المخيم كما ضاع الوطن” (ص 267).
القصص تصف وتحتج وتتهم: “فالبلد الذي يقتل أحلامنا ليس وطناً، والبلد الذي يحرمنا من حقوقنا المدنية كافة ليس وطناً” (ص 260)، وهي لا تعفي الذات من مسؤوليتها، بل تضع يدها على الجراح من دون أي مواربة: “ثم إنه ما كان دور التنظيمات بعد التخلي عن الثورة من 25 عاماً إلى اليوم؟ 25 عاماً لا ثورة ولا استثمار؟!” (ص 122).
كما تُنتج الخسارات حكمتها الموجعة: “لم يكن يكفي أن ننجو من الرصاص الطائش حتى نكون قد نجونا من الحرب” (ص 269)، و”لم يقتصر فقداننا على الذين ماتوا بل امتد إلى الأحياء الذين أحببناهم” (ص 281).
والخسارات تستدرج السخرية على امتداد صفحات العمل: كان “أبي يريق دماء الأعداء في الجنوب اللبناني” (ص 288)، و”في قصص أبي لم يذق الفدائيون طعم الخسارة قط” (ص 295).
تقول مضامين هذا العمل القصصي للجميع عامة، وللسياسيين خاصة: إن الجرح لا يزال مفتوحاً، وإن مراوحة المكان لا توقف عجلة الزمن، وإن الأحلام الجماعية تتحول كوابيس فردية لا شفاء منها، وإن المشهد المفكك يزداد تفككاً بغياب مشروع يقدّم اقتراحاً، وبغياب قيادة حيّة تشير بيدها إلى الوجهة.
هذه المجموعة رزمة خرائط لشكل المنافي المتجددة، لأسئلة الروح، لوجهة القلب، لهندسة القسوة، لكنها مع هذا كله لا تعلن الانكسار، وإنما تدين وتتهكم وتتذكر وتحلم بما يكفي لتحس أن جسد البلاد، بعد 73 عاماً على النكبة، لا يزال دافئاً.
المشاركون وعناوين قصصهم:
أيهم السهلي: “سيناريوهات لحكاية طوني”؛ سماح حمزة: “حب تحت الاحتلال”؛ ميرا صيداوي: “بيت المسعود”؛ ناديا فهد: “إلى ابنتي جفرا”؛ لمى أبو خروب: “زيارة مستعجلة”؛ يوسف نعنع: “الهجرة: موت أو نسيان…”؛ آمنة الأشقر: “المقاومة على أشكالها تقع”؛ وسيم السلطي: “على الحافة”؛ علاء العلي: “رذالة ولائحتي البيضاء وأقوى من الجاذبية”؛ خالد النعنع: “معشوقة جدّي”؛ محمد خالد: “مرآة المخيم”؛ سمر محمد: “سأصير يوماً ما أريد”؛ صابرين أبو العلا: “طرقات”؛ رنا عيسى: “قصة الحن والقرش وبعض النباتات”. —- عدد الصفحات 295 —-غلاف عادي