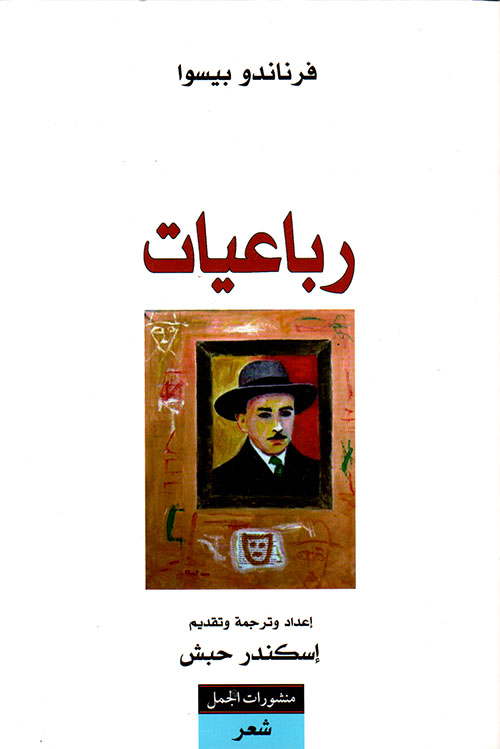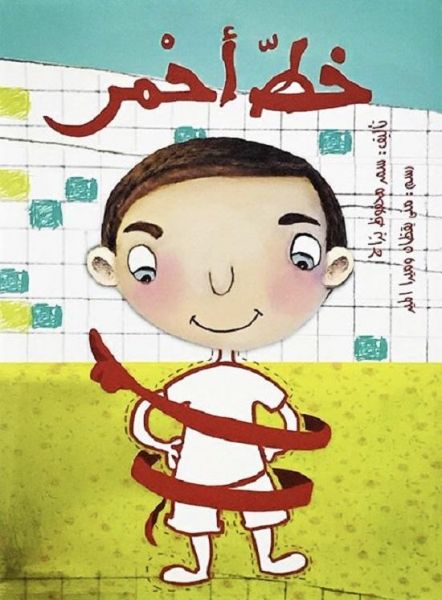الوصف
في هذه الرباعيات المترجمة (تركيب شعري في العديد من بلدان العالم)، يحاول بيسوا أن يذيب كتابته في نوع أدبي وفي حساسية معينة، خاصتين بطائفة ما. يحاول أن يحذف أيضاً تلك الرباعيات التي وجد بأنها “شخصية” جداً. ما يؤكد ذلك ملاحظاته التي كتبها على هامش هذه الأوراق الستين. من هنا يبدو أن هذا المشروع في نزع الصفة الشخصية عنها، هو في الوقت عينه، مشروع أكيد وملطف.
مشروع أكيد، لأن هذه المحاولة في نزع “الشخصانية” المشتهاة، تلتقي بتلك الحركات المتعاقبة لذلك “البحث/الرفض” للهوية، الذي يشكل العنصر المؤلف الحقيقي لعمل بيسوا الأدبي برمته. عمل أكيد، لأن هذه الرباعيات تشكل جزءاً من ذلك التيار الكبير الذي افتتحه شعراء التروبادور الغالسيين/البرتغاليين منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر والذي اجتاز “عصور الشعر الشفاهي والمكتوب، العليم والساذج” (راجع كتاب أنطولوجيا “شعراء التروبادور الغاليسيين- البرتغاليين” منشورات p.o.l، فرنسا العام 1987). ففيها نعود لنجد هذه الموتيفات والميلوديا والمناخ والأمكنة والحالات والحركات الشكلانية وأقل قواعد الأورثوذكسية -في اللعب على المتوازيات عبر الاستعادات التي تذكرنا بأناشيد القرون الوسطى كما بأشكال الشعر عند جيرانه الإسبان.
ومع ذلك فنحن أمام مشروع ملطف، إذ على الرغم من هذه الإرادة المؤكد والاهتمامات التي انحاز لها، إلا أن بيسوا لم يستطع أن يمنع نفسه من القول، من أن يفرد هواجسه: نزع الشخصانية نفسها، “التفكير/الإحساس” في تضاداتهما، الإخلاص، “الصدق-الكذب”، السعادة عبر الوهم، الوحدة بين الجماعة، “العدم” (أو اللاشيء، وهو الذي يمثل مصدر الأشياء كلها ونهايتها)، المرح وهذه الحساسية القاتلة التي تتباهي كي تقنع نفسها.
كتبت جميع هذه الرباعيات تقريباً في الفترة التي صدر فيها ديوانه “رسالة” (وهو الديوان الوحيد الذي صدر وبيسوا كان لا يزال على قيد الحياة) من هنا تحمل، الرباعيات كما قصائد “رسالة”، ذلك الشعور الوطني “الطازج”، حتى في “كليشيهات” مراجعها.
وبالعودة لمتن هذه الرباعيات نجد أن غالبيتها هي قصائد حب، ربما كانت تشكل وحدها قصائد الحب في شعر فرناندو بيسوا، إذ لا نعرف للحب أي موضع آخر في قصائده العديدة، في أسمائه المتعددة. إنه الحب الخجول، الحب المتواضع، الحب العذري، الحب الشهواني، الحب المليء بالغيرة، الحب الذي لا يشعر مطلقاً بالاكتفاء، الحب الحالم، الحب اللطيف، الحب المنتقم، الغياب، المرارة، تلك المسحة من كراهية النساء. ثمة فتاة شابة “تسيطر” على مناخ القصيدة. شابة مغناج، خرقاء، غير مبالية، صادة أو بالكاد يلحظها… شابة تأسر شخصيتها بلباقة، تغلي أحياناً بوقاحة موسومة. يحدث له أن يحدثها باسمه الشخصي عبر ريشة الشاعر مثلما نجد ذلك في “أناشيد الصديق” عند “الترويادوريين”.
تنتظم القصيدة حول عناصر من الحياة اليومية الشعبية: “كشتبان الخياطة”، لفيفة الصوف، الثوب، أصيص الحبق، القبعة، القرط، التنورة الزرقاء، القميص الأحمر، الدبوس، الشال، المروحة، المقص، حبة القهوة، الخيط، الأغاني، الخ…
كذلك نجد “أشخاص” القصيدة في العمل، أمام الغربال، يسهرون لأنهم لا يستطيعون النوم، ينظرون من زاوية النافذة، يتنزهون كي يبرزوا أنفسهم ولكي يشاهدهم المارون الآخرون، ينسجون الصوف والدانيتلا، يأكلون “القريدس”، يشترون الأسماك، يحضرون الحلوى، يتمشون في الساحة، يقفون أمام الكنيسة. ونحن معهم أيضاً فوق الدروب بأسرها، في الريف، في المدينة. أشخاص يراقبون ملامح الطبيعة بانتباه، يراقبون رمزية الغيوم. يستحضرون حقول القمح، الحصاد، الطواحين، الآبار، الجدران، شتلات الزهور، الحدائق، السنونوات، العندليب، البطيخ، الكرز، الخمر… إنهم يحبون الأنهار ويكرهون البحار.
بعض هذه الرباعيات تنحو “بالعبث” صوب الحنان: “إنه اللامعنى” الصافي، الذي يشكل صدى لتلك القصائد الهجائية التي انتشرت في القرون الوسطى. إنه الوضوح المعتم لهذه “البديهية” المكبلة